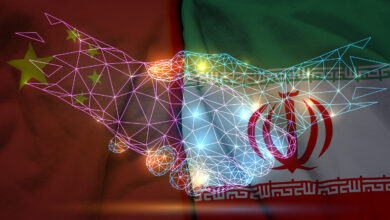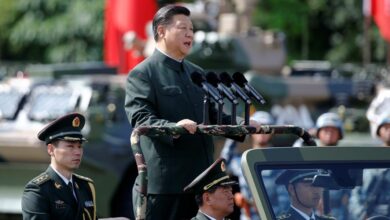هل من الممكن إعادة إنتاج “سيناريو شرق الفرات” في السويداء؟

بقلم: عريب الرنتاوي..
فتح انضمام سوريا للتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، الباب أمام التطوّرات المتسارعة في غربي الفرات، وبالذات في شرقه وشماله، والتي انتهت بمسلسل انهيارات مفاجأة أصابت “قسد” في مقتل.. فهل يفتح التحاق دمشق، بعربة من عربات القطار “الإبراهيمي”، الباب أمام تطوّرات مماثلة في السويداء؟.. وهل إعادة إنتاج سيناريو شرق الفرات، ممكناً في جنوب سوريا؟.. أين يلتقي وأين يتفرّق المساران؟.. وما هي الفرص والعقبات التي تعترض مشروع بسط سيادة الدولة السورية، على “المحافظة المتمرّدة” في الجنوب؟.
أولاً.. في انهيارات “قسد“
عبّر الموفد الأمريكي توم برّاك، كما لم يفعل غيره، عن السبب الرئيس وراء الانهيارات المفاجئة والمتلاحقة، التي أصابت الحركة الكردية المسلحة، بقوله، إنّ المهمّة الرئيسة للحركة قد أنجزت، ولم يعد ثمّة من مبرّر لاستمرارها خارج الدولة السورية… انهيارات لا يشبهها من حيث طبيعتها وسرعتها، سوى الانهيار المفاجئ والسريع، لنظام الرئيس بشار الأسد… اجتماعا باريس وأربيل، دشّنا رفع الغطاء الدولي (اقرأ الأمريكي) عن “قسد”، تماماً مثلما كان اجتماعا بغداد الثلاثي (سوريا، العراق وإيران)، والدوحة (آخر اجتماع لمسار أستانا)، إيذاناً برفع الحلفاء مظلتهم عن نظام متهالك، بلغ به التآكل الداخلي مبلغه.
لكن ما لم يتطرّق له الموفد “الثرثار”، هو أنّ تفويضاً آخر، كان قد سحب “موضوعياً” من بين يدي “قسد”، وربما كان في أزمنة سابقة أكثر أهميةً، وهو استهداف النفوذ الإيراني في سوريا، وتقطيع شرايين التواصل والإمداد الممتدة من طهران إلى الضاحية الجنوبية… حدث ذلك، من دون أن يكون لـ”قسد”، “الفضل” في تحقيقه، بل ومن دون إسهام جدّي من لدنها في إنجازه، بعد أن أخفق نظام الأسد، في التقاط التحوّلات التي طرأت على الأزمة السورية، والبيئة الإقليمية-الدولية من حولها، والبناء على مقتضياتها.
ثانياً.. هل إعادة إنتاج هذا السيناريو ممكنة في السويداء؟
نشوة الانتصارات السريعة وغير المكلفة، التي تحقّقت لدمشق، على جبهة الشمال-الشرقي، دفعت بكثيرين للحديث عن فرص واحتمالات إعادة إنتاج هذا السيناريو جنوبي البلاد، السويداء على وجه التحديد، وسط إدراك متفاوت لاختلاف الظروف المحيطة بكلا الرقعتين، محلياً، والأهم إقليمياً.
إذ بخلاف شرق الفرات، البعيدة نسبياً عن الذراع الإسرائيلية، تبدو السويداء على “مرمى حجر” من أوّل خط دفاعي (اقرأ هجومي) إسرائيلي في الجولان والقنيطرة، وأرياف درعا وبعض أرياف دمشق، التي باتت عرضة للتعدّيات الإسرائيلية اليومية، هذا “الموقع” يعطي السويداء وحراكها الانفصالي، ميزة لا تتمتع بها مناطق الجزيرة وشرقي الفرات، ولم تحظَ بها “قسد”، أقله من منظور استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلية.
بخلاف “قسد” والحركة الكردية، التي تحدّثت “إسرائيل” مراراً وتكراراً، عن رغبتها واستعدادها، لمدّ الغطاء لها، فإنّ الالتزام الإسرائيلي حيال دروز السويداء، كان دائماً، أعلى وأشدّ بكثير، مردُّ ذلك يعود لعاملين اثنين: أولهما؛ وجود “لوبي درزي” مؤثّر في السياسات الداخلية الإسرائيلية، وهو ما لا يتوفّر للكرد… وثانيهما؛ أنّ السويداء تندرج في الحسابات الإسرائيلية في سياقات “المنطقة الآمنة” الجنوبية، ووضع اليد الإسرائيلية على كلّ ما يتصل بها، أولوية راهنة، بخلاف نظرة “تل أبيب” للكرد وغيرهم من الأقليات، بوصفها “أحصنة طروادة” مرصودة لتقسيم سوريا وتفتيتها، وهو هدف قائم، ولكنه منذور للمديين المتوسط والبعيد.
ثانيها؛ سيناريو “التأجير” على غرار ما حصل في الباقورة والغمر، الجيبين الأردنيين اللذين احتلتهما “إسرائيل”، وقبلت بإنهاء احتلالهما نظير تأجيرهما لها لمدة 25 عاماً بموجب معاهدة السلام 1994… أحسب أنّ الجولان بمكانته الاستراتيجية، ومن حيث كثافة الاستيطان فيه، يجعل المقارنة والمقاربة، شديدتي التبسيط والتسطيح.
ثالثها؛ معادلة “السويداء مقابل الجولان”، التي يجري تداولها، تبدو بدورها وصفة موصوفة لبداية العد العكسي للنظام في دمشق، يحتاج الأخذ بها، قدراً كبيراً من “الخفّة” و”الحماقة” و”قصر النظر والنفس”، وهي وإن كانت مطروحة على الطاولة، إلا أنها لا تبدو مرجحة، أقلّه من باب التحليل المنطقي.
رابعها؛ من زاوية استخدام “العشائر العربية” في الجنوب، كما حصل في الشمال الشرقي، يبدو وضع السويداء أقرب إلى الحسكة والقامشلي، منها إلى الرقة ودير الزور، حيث الأغلبية العربية ظاهرة للعيان… الجيش والعشائر توقّفا عند بوابات الحسكة وعين العرب-كوباني، لحسابات الديمغرافية والأغلبية الكردية، وقد تكون عشائر الجنوب العربية في حال تحرّكها، بدعم من دمشق، مجبرة على التوقّف ثانية، على عتبات السويداء بغالبيتها الدرزية الظاهرة هذه المرة،
خامسها؛ ليس مستبعداً أن تكون السويداء، بانتظار سيناريو سقوط “القلعة من الداخل”، كأن يُعاد الاعتبار للتيار الوطني-العروبي من أبناء “بني معروف”، ولقد علت أصواتهم عالية في بدايات الأزمة، قبل أن تخفت وتتراجع، جرّاء المعالجات الخاطئة للنظام، التي دفعت بكثير من أبناء المحافظة ورموزها الدينية والسياسية إلى أحضان “حكمت الهجري”، وتياره المنادي بالالتحاق بالفضاء الإسرائيلي.
يوماً ما، سيدرك الدروز، أنهم أقليّة صغيرة، في بحر سُنيّ متلاطم الأمواج، وأنّ “اللحظة الإسرائيلية” في المنطقة، التي فرضتها سياسات “التوحّش” و”الهيمنة” طارئة مهما طالت واستطالت، وأنّ من مصلحة الطائفة على المدى الأبعد، أن تكون على “عروة وثقى” مع محيطها العربي-الإسلامي، وأن لا حلَّ درزياً للمسألة الدرزية، وأنّ سوريا الوطنية-الديمقراطية-التعددية، هي الحلّ للجميع، وليس لهم وحدهم.
هي ليست مسؤولية الدروز وحدهم للوصول إلى سوريا موحّدة وحافظة للتعدّد والتنوّع، ولنظام شامل، لا يُقصي أحداً، ولدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها وبناتها، كياناتها ومكوّناتها، بل هي مسؤولية “الكلّ السوري”، وفي المقدّمة النظام الممسك بتلابيب السلطة والقرار في دمشق.