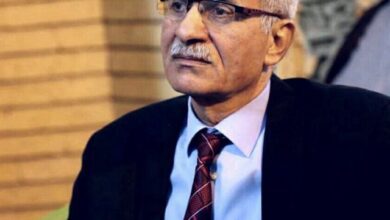سوريا ما بعد الحرب.. بين دولة المواطنين وجزر الطوائف

بقلم: سليمان أمين..
في مشهد سياسي ممزّق ومجتمع أنهكته الحرب، يبقى السؤال الجوهري: هل تستطيع سوريا إعادة بناء دولة جامعة، أم أنها تتجه نحو كيانات طائفية منفصلة تتجاور ولا تتعايش؟.
بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الصراع السوري، لم يعد السؤال الجوهري يتعلق بوقف إطلاق النار أو شكل الحكومة المقبلة، بل بما إذا كان السوريون قادرين على استعادة مفهوم الدولة نفسها. فالحرب لم تُسقط نظاماً أو تغيّر حدوداً فحسب، بل أعادت صياغة الهوية الوطنية، وأثارت الشك في إمكان استمرار سوريا ككيان سياسي واحد. وبينما تتراكم المبادرات الدولية وتتناوب القوى الإقليمية على مساحات النفوذ، يبقى السؤال معلّقاً: هل تتجه سوريا نحو دولة حديثة تقوم على مبدأ المواطنة، أم أنها تنزلق ببطء نحو جزر طائفية متجاورة لا تجمعها سوى ذاكرة جغرافية واحدة؟.
الحقيقة المؤلمة أن الحرب لم تكتفِ بتغيير موازين القوى السياسية، بل أعادت تشكيل مخيلة المجتمع. فالمناطق التي كانت متصلة بفكرة «الوطن» أصبحت اليوم أشبه بخرائط متوازية، لكل منطقة سرديتها وخوفها وثقافها المحلية. ووسط هذا التشظّي العميق، بدأ السوريون يعرّفون أنفسهم بأنماط انتماء ضيقة: طائفة، عشيرة، إثنية، منطقة. الهوية الوطنية التي بدت يوماً صلبة تلاشت تدريجياً لصالح انتماءات فرعية كان يجري كبتها أو تهميشها، لكنها عادت إلى السطح بعدما انهارت مؤسسات الدولة وتناقضت سلطات الأمر الواقع.
ومع ذلك، فإن انهيار القديم لا يعني بالضرورة استحالة بناء الجديد. ففكرة «دولة المواطنين» لم تعد ترفاً سياسياً أو شعاراً نخبوياً، بل تحولت إلى الشرط الوحيد لبقاء سوريا موحدة ولو بالحد الأدنى. فالدولة القائمة على المساواة أمام القانون هي وحدها القادرة على استيعاب هويات السوريين المختلفة من دون أن تتحول هذه الهويات إلى عوامل تهديد متبادل. غير أن الوصول إلى هذه الدولة يحتاج أولاً إلى إعادة بناء الثقة، وهو الشرط الأصعب في بلد دُمّرت فيه الثقة قبل أن تُدمّر المدن. فالسوري الذي عاش الحرب لا يبحث عن خطاب وطني رومانسي، بل عن دولة تحميه من السلاح، وتحترم حقه، ولا تختزله في طائفته أو منطقته.
لكن الطريق نحو دولة المواطنة ليس سالكاً. فواقع ما بعد الحرب يعكس تشكّل أمر واقع جديد: سلطات محلية، إدارات ذاتية، ونقاط نفوذ إقليمية تحوّل البلاد إلى فسيفساء جغرافية ومجتمعية. هذا النموذج، إذا استمر، لا يفضي إلى الاستقرار بل إلى شكل من «السلام البارد» الذي يُبقي النزاعات في حالة كمون. فالدول التي تُبنى على الهويات الطائفية لا تستقر؛ فهي تحتاج باستمرار إلى حماية خارجية، وتعيش على خوف دائم من أي تغيير ديموغرافي أو سياسي. كما أن كل منطقة تصبح بحاجة إلى رعاتها الإقليميين والاقتصاديين، ما يجعل قرارها الوطني مشتبكاً مع مصالح دول أخرى. سوريا في هذه الحالة لن تكون دولة بالمعنى الحديث، بل مجموعة من الكانتونات التي تتجاور ولا تتكامل، وتتنافس بدل أن تتشارك.
إضافة إلى ذلك، فإن استمرار هذا التفكك سيقوّض أية إمكانية لاقتصاد وطني. فاقتصاد الجزر الطائفية لا يقوم على الإنتاج بل على الريع، ولا يعرف التخطيط المشترك بل يخلق أسواقاً متوازية تعيش على التهريب والتجارة غير الرسمية. وفي بلد يحتاج إلى عشرات المليارات لإعادة الإعمار، فإن غياب المركز السياسي والاقتصادي سيجعل الاستثمار الخارجي غير مستقر، وسيبقي المجتمع أسير اقتصاد هشّ يعتمد على المساعدات والتحويلات والمبادرات المحلية المحدودة. عندها ستولد طبقات اقتصادية جديدة مرتبطة بولاءاتها أكثر من ارتباطها بوطن يجمعها، وسيتحوّل الفقر إلى جزء من البنية العامة لا إلى ظرف طارئ.
في المقابل، تقف تحديات عميقة أمام أي مشروع وطني. فالتدخلات الخارجية لم تتراجع، بل تعمقت، والنفوذ العسكري والاقتصادي لقوى متعددة يجعل القرار الوطني محاصراً. كما أن الخلافات داخل المعارضة والنظام على حد سواء تجعل من الصعب بلورة رؤية وطنية موحدة. وفي ظل غياب قيادة سياسية جامعة تمتلك شرعية داخلية وإقليمية، تبقى الجهود الوطنية مشتتة وغير قادرة على خلق زخم فعلي نحو إعادة تأسيس الدولة.
ورغم ذلك، فإن مستقبل سوريا لا تحدده الخرائط العسكرية بقدر ما تحدده رغبة السوريين أنفسهم في الخروج من منطق الحرب. إذ أنه في لحظة ما، ستتراجع الحروب الصغيرة لصالح سؤال أكبر: ماذا يبقى من الوطن إذا عاش كل في جزيرته؟ وعندها سيكتشف الجميع، أن الطائفية قد تمنح شعوراً مؤقتاً بالأمان، لكنها لا تبني دولة، ولا تحمي مجتمعاً، ولا تخلق اقتصاداً. وأن المواطنة، رغم أنها الطريق الأصعب، هي الوحيدة التي تمنح لكل فرد مكاناً في وطن لا يُدار بالخوف ولا بالولاءات، بل بالحقوق والواجبات.
إن سوريا اليوم ليست دولة مكتملة، ولا كانتونات مستقرة، بل مساحة معلّقة بين سيناريوهين. ما سيحدد مستقبلها ليس اتفاقاً دولياً ولا نصاً دستورياً فحسب، بل عودة السوريين إلى فكرة أن الوطن لا يُبنى بالطائفة، ولا يُحمى بالسلاح، ولا ينهض بالولاء، بل بإيمان الناس بأنهم شركاء في مصير واحد. وإذا كان للأمل مكان، فهو أن هذا الإدراك بدأ يظهر ببطء تحت ركام الدمار، وكأن الوطن يلمّ شتاته رويداً، باحثاً عن فرصة جديدة ليولد من جديد، هذه المرّة كدولة مواطنين حقيقية.. لا كجزر طوائف بلا أفق.